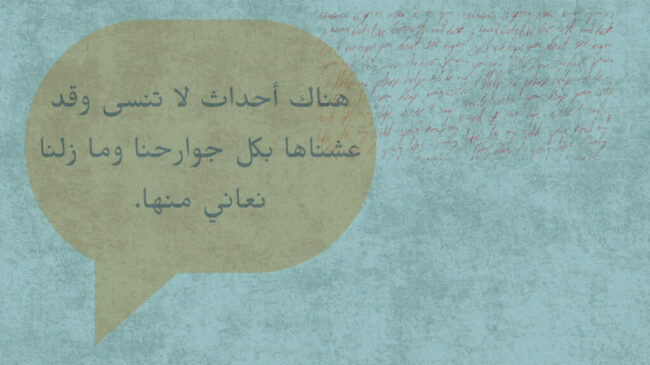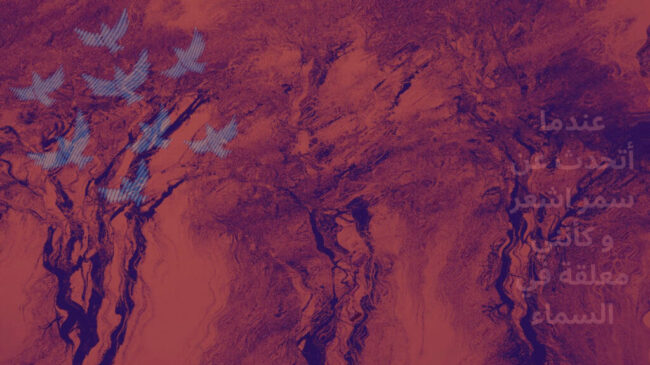لا أذكر بالتحديد متى كان لقائي الأول مع سمر، لكن ذلك لا يهم. المهم أنني التقيت بها.
كان ذلك في أحد الأيام في عام ٢٠١٢ قبل بدء العمليات العسكرية في مدينة حلب، أي قبل رمضان ذلك العام ببضعة أشهر.
كنا في “دير القديس ورطان” للآباء اليسوعيين في منطقة الميدان، حيث بدأنا باستقبال العائلات النازحة التي قدمت إلى حلب من حمص وإدلب ودير الزور، حيث اشتد هناك قصف النظام للمناطق التي ثارت ضده، مما دفع الآلاف من المدنيين لهجر مساكنهم واللجوء إلى حلب. كان الحراك الثوري بحلب آنذاك قد اتخذ بأحد أشكاله طابعاً إغاثياً.
كنا مجموعة من المتطوعين/ات المؤمنين/ات بالثورة، أطلقنا على أنفسنا اسم “العائلة”. عملنا لشهور على تأمين مساكن لعشرات العائلات النازحة وعلى تزويدهم ببعض المواد الغذائية والدوائية.
رأيت سمر للمرة الأولى برفقة ميزر مطر في دير ورطان. كانا قد سمع عن نشاطنا بطريقة ما وجاء للعمل معنا. كان عندنا، أقله في تلك الفترة، سياسة غير مكتوبة، فرضها الحرص الأمني٫ تقتضي منا التأكد من “ثورية” المتطوعين معنا لضمان أمننا وأمن العائلات التي ندعمها. لا أذكر من زكّا سمر بيننا، لكنها كما ظهر جلياً كانت أسمى من أية تزكية.
لا أذكر شيئا عن أول حديث خضناه، لكني ذاكر ما دار برأسي حينها “أين كنتم وأين كنا، وكيف لم نلتقِ من قبل. يالا بشاعة النظام الذي نجح لعقود بمنع أشخاص مثلنا من اللقاء، حتى جاءت الثورة وجمعتنا”.
هذا كان شعوري حين التقيت بتلك الشابة “الأتاربية”, الجميلة قلباً وقالباً، الثائرة على الظلم، الخارجة عن قيود المجتمع والدكتاتورية، طيبة الروح، سخية الدمع، التي لا تيأس ولا تكل.
أذكر أيضا أننا وفي لحظة ما اكتشفنا أنني على معرفة سابقة بشقيقتها رشا. أصبح لصداقتنا بعد عائلي.
منذ أول لقاء لي بسمر، جمعتني معها عدة مواقف محورية رسمت لي مسار تلك الفترة بشكل جذري.
أول تلك المواقف كان يوم النزوح الكبير في حلب حين بدأ القصف على منطقة صلاح الدين وجوارها.
كنت وسمر في اجتماع مع مجموعة أخرى من متطوعين من مبادرات مختلفة نناقش كيفية تأمين مساكن للنازحين. خلص الاجتماع على فتح المدارس الرسمية وتحويل صفوفها إلى مراكز إيواء جماعية.
خرجنا من الاجتماع وتوجهنا مع آخرين نحو مدرسة “هدى الشعراوي” في حي الزهور. دخلنا المدرسة بعد أن أقنعنا الحارس أننا نملك موافقة مديرية التربية. وبذات الطريقة دخلنا مدرسة اسكندرون المجاورة، التي أصبحت سمر لاحقاً مسؤولة عنها مع صديقها أحمد عقلة.
أمست سمر وبوقت قصير صديقة للعائلات التي التجأت إلى مركز الإيواء، وأماً لأطفالهم. كانت تحرص على قضاء الوقت بين الأطفال لتخفف عنهم صدمة الحرب والنزوح، وتخفف عن كاهل أهلهم معاناة التعامل مع نشاطهم وفرط نشاطها.
في موقف آخر، ذهبت معي سمر وبدعوة من أحد الكهنة لزيارة نشاط شبابي من أكثر الانشطة المسيحية رواجاً في المجتمع الحلبي الذي يمكن أن يوصف بالمخملي.
كان بعض الشباب الحاضرين متوجسين من الثورة نتيجة خوفهم من أية “أسلمة” محتملة لها، لم تكن قد طغت حينها بعد على طابعها المدني.
لكن عدم المعرفة بالآخر المختلف والخوف منه كان عاملاً مؤججاً لتلك المخاوف المبكرة. دخلت سمر اللقاء وعرفت عن نفسها وتحدثت عما تعني لها الثورة. قاربت سمر مخاوف الحاضرين، وعرّت بعفويتها كل بعد مناطقي، وطائفي، وطبقي يفصل بين أبناء حلب وريفها.
كان لحديثها وقع ثقيل على الحاضرين واختلفت ردة فعلهم عليه. لا أدري إن أعاد بعضهم النظر مخاوفه بعد ذلك اللقاء، لكني متيقن أن ما سمعوه كان أكبر من اللحظة. كان بحد ذاته حاملاً لمقومات ثورات عدة وليس ثورة واحدة فقط.
لاحقاً، وفي إحدى جلساتنا في مدرسة اسكندرون، فاجأتنا سمر أنها حصلت على منحة لاستكمال دراستها في ترميم الآثار على ما أذكر، وأنها ليست راغبة بأن تأخذها. أعتقد أنها كانت المرة الثانية التي كانت تنوي فيها التخلي عن حلمها بالماجستير من أجل الثورة. أذهلتني قوتها.
لكن هذه المرة شجعناها نحن الحاضرون المتأثرون بعظمة حلمها وإيمانها، بضرورة أن تستكمل دراستها في الخارج. فما أحوج سوريا إلى أخصائيات بترميم الآثار ممن يملكن قيم مثل قيم سمر.
اجتمعنا بعد فترة لنودعها حيث وثقت شقيقتها ميسا لقاءنا بفيديوهات شاركتهم معنا بعد أعوام. ضحكت وضحكنا. بكينا وبكت.
لم نكن ندري أن لقائنا ذاك كان سيكون الأخير قبل أن يخطفها عناصر داعش في مدينتها الأتارب بعد زيارة قامت بها بعد أشهر بسيطة من بدء دراستها في الخارج، وغيبوها قسراً عن أهلها وأحبائها مع رفيق النضال المصور الصحفي محمد العمر.
خطفها من كانت لهم عدواً أولاً. فهي ابنة بلدتها، التي رفضت أن تنصاع لقمعهم وتجبّرهم. وكيف لها أن تنصاع وهي الحرة الثائرة على أعتى دكتاتوريات الأرض.
غابت سمر مع محمد، ونحن ما زلنا ننتظر الكشف عن مصيرهما وعودتهما بأقرب وقت.
سمر لم تكن إلا صورة جميلة لثورتنا، تجلياً لأسمى أحلامنا، وحقيقة لن يتمكنوا من تغييبها مهما فعلوا.
شكراً سمر لمن أنت، شكراً لما فعلت، وأسفاً أن حلمك لم يتحقق بعد، وإنما للحلم بقية.